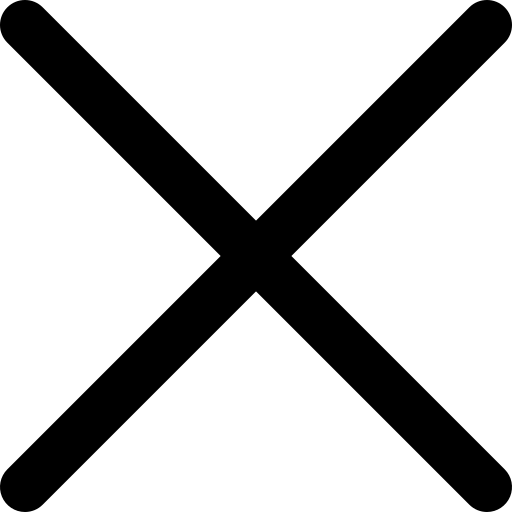عظمى خاتون
أحدثت قضية الشابة "نيكّي بهاتي" صدمةً كبيرة، بعدما أُحرِقت حيّة على يد أسرة زوجها بسبب الدوطة، غير أنّ هذه المأساة ليست فريدة من نوعها؛ فإحصاءات المكتب الوطني لسجلات الجريمة في الهند تكشف عن نحو عشرين وفاة مرتبطة بالدوطة يوميًّا. وتعكس هذه الوقائع الوجه المظلم للممارسة التي كان يُفترض أن تحمي المرأة وتدعم مكانتها، فإذا بها تنقلب إلى أداة للجشع والاستبداد والعنف.
الدوطة هي المال أو الممتلكات أو الهدايا التي تجلبها العروس إلى زواجها. وقد اعتُبرت في الأصل هديةً من أسرتها لمساندتها في بداية حياتها الجديدة. وفي الإطار القانوني، تُعرَّف الدوطة بأنها كل ما له قيمة يُطلب أو يُتبادَل عند الزواج، بينما لا تدخل الهدايا الطوعية في هذا المفهوم. وفي كثير من المجتمعات، تتجسد الدوطة في النقود أو الحُلي أو الأجهزة المنزلية. وبسبب ما تواجهه النساء غالبًا من عوائق في وراثة ممتلكات الأسرة، تبرَّر الدوطة أحيانًا باعتبارها نصيب الابنة من ثروة العائلة.
وكانت الدوطة في بداياتها وسيلةً لصون حقوق العروس وضمان مستقبلها، غير أنها بمرور الوقت تحوّلت إلى أداة تستقوي بها أسرة الزوج. وما كان يُمنح يومًا بروح العطاء، غدا التزامًا قسريًا يُفرض بالضغط أو بالتهديد.
وتغرق العديد من الأسر الفقيرة في الديون محاولةً لتلبية متطلبات أصهار بناتها، فتتحول الفتيات إلى سلعة للمساومة في سوق الزواج. وانتقلت الدوطة من كونها نظامًا اجتماعيًا يراد به حماية المرأة إلى ممارسة تُكرّس أشكال الاستغلال والإذلال بحقها.
ويُجادل أنصار الدوطة بأنها تمنح المرأة ثروة، وترفع من قيمتها ومكانتها في بيت الزوج، كما تعزز المكانة الاجتماعية لعائلتها، غير أن الواقع يكشف غير ذلك؛ فمعظم ما يُقدَّم من نقود أو ملابس أو مجوهرات لا يبقى تحت تصرف المرأة، بل يُدمج سريعًا في ممتلكات أسرة الزوج، فلا يضمن لها استقلالًا ولا يوفر لها أمانًا.
وتترتّب على الدوطة عواقب خطرة؛ فهي ترسّخ فكرة أن البنات عبء وأن الأبناء استثمار، وتُرغم الأسر على إنفاق مبالغ باهظة. كما تفتح الباب واسعًا أمام الفساد، إذ كثيرًا ما تُهمل الشرطة والمحاكم قضايا المضايقات أو الوفيات المرتبطة بالدوطة. وإلى جانب ذلك، يُشجّع على النزعة الاستهلاكية والتفاخر الطبقي، مما يحوّل الزواج من رباطٍ مقدّس إلى صفقة مالية.
وتدفع كثير من النساء حياتهن ثمنًا لهذه الممارسات. فعندما تعجز الأسر عن تلبية المطالب، تتعرض العرائس للمضايقة والتعذيب، بل وللقتل أحيانًا. وتشير الإحصاءات الرسمية في الهند إلى تسجيل ما يقارب ستة آلاف وفاة مرتبطة بالدوطة سنويًا، فيما يُرجَّح أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير بسبب ضعف الإبلاغ. وخلف كل رقم حكاية لابنة أو زوجة، وأحيانًا أم، انطفأت حياتها بفعل الجشع.
ولقد أسهمت المعتقدات الثقافية والدينية أيضًا في ترسيخ التمييز وعدم المساواة. ففي بعض التقاليد تُعتبر المرأة خاضعة للأب أو الزوج أو الابن، ويُختزل الزواج ليكون السبيل الوحيد إلى نيل الاحترام الاجتماعي أو الكمال الروحي. كما أسهمت القصص والطقوس في تمجيد صورة الزوجة المطيعة التي تفني ذاتها من أجل زوجها، حتى لو كان الثمن حياتها. وهكذا ترسخت عبر الأجيال رؤية تجعل خضوع المرأة أمرًا طبيعيًا ومقبولًا.
وصدر قانون حظر الدوطة عام 1961م، ثم عُدّل لاحقًا ليصبح أشد صرامة. وعلى الرغم من أن تقديم الدوطة أو قبولها يُعدّ أمرًا غير قانوني من الناحية الرسمية، فإن أثر القانون على أرض الواقع محدود. فكثير من الأسر تتردد في الإبلاغ عن القضايا خشية الوصمة الاجتماعية، فيما تتجاهل الشرطة والمحاكم شكاوى الضحايا، ويزيد الفساد من إضعاف آليات التنفيذ. وقد صرّحت نساء كثيرات بأسماء من أساؤوا إليهن قبل وفاتهن، ومع ذلك رفضت المحاكم اعتماد أقوالهن كأدلة معتبرة. وهكذا ظلّ الإنصاف أمرًا نادر الحدوث.
وتستمر الدوطة في الوجود لأنها مرتبطة بمعتقدات اجتماعية عميقة، وهيمنة ذكورية، وانقسامات طبقية. وتعكس وفيات الدوطة مجتمعًا يقيس قيمة المرأة بما تملكه من ثروة. وما لم يحدث تغيير جذري في التقاليد والقوانين والعقليات، ستبقى الدوطة وسيلةً للاستغلال.
وغالبًا ما يُنظر إلى التعليم كأحد أهم الحلول الأساسية، وهو بالفعل يؤدي دورًا في التوعية وترسيخ المساواة بين الجنسين، وتعزيز ثقة النساء بأنفسهن. وقد سعى ناشطون إلى مراجعة الكتب المدرسية، وتأهيل المعلّمين، وإطلاق حملات توعوية لنشر هذه القيم.
ومن المفارقات المؤلمة أنّ التعليم، الذي يُفترض أن يكون سبيلًا للتحرّر، قد يسهم أحيانًا في زيادة متطلّبات الدوطة؛ إذ يُنتظر من الفتاة المتعلّمة أن تجلب دوطة أكبر تتناسب مع مستوى تعليم عريسها. وغالبًا ما تُنفق العائلات على الدوطة أضعاف ما تُنفقه على تعليم بناتها، وكلاهما يُعامَل باعتباره نفقات لا استثمارات. بل إنّ الفتيات اللواتي يتجاوزن عتبة معيّنة من الدراسة يواجهن فرصًا أقل في الزواج، إذ يرفض كثير من الرجال الارتباط بـ"عروس مفرطة التعليم". وهكذا تُثبَّط عزائم الفتيات عن مواصلة التعليم، ويُدفعن إلى التسرب المدرسي بنسبة أعلى.
وتتجذّر مشكلة الدوطة في البنية الثقافية والطبقية والدينية والاقتصادية، وهي ليست قضيةً هندية فحسب، بل مشكلة عالمية حيث تُعامَل المرأة كملكية. وقد أسهم الدعم الدولي، وحملات التوعية، والحركات النسوية في إبراز قسوة الدوطة، غير أن التغيير الحقيقي لا بد أن ينبع من داخل المجتمع نفسه.
وإن نظام الدوطة بصورته المتداولة اليوم لا يمت إلى لإسلام بصلة. فالزواج في الإسلام يُعدّ عقدًا مقدسًا يقوم على الاحترام المتبادل والرضا الحر بين الطرفين، لا على المعاملات المادية، ولا تُعتبر المرأة عبئًا، بل يُعدّ تربية البنات بحبٍّ ورعاية عملاً شريفًا. ويبدأ الزواج بعقد النكاح الذي ينعقد بموافقة العروس والعريس، وللمرأة الحق في رفض أي زواج تُجبر عليه. فالزواج في جوهره ميثاق للمودّة والدعم وبناء الأسرة، لا للصفقات المالية.
ومن المؤسف أن تقاليد الدوطة وجدت طريقها إلى المسلمين في الهند رغم مخالفتها لتعاليم الإسلام. فقد تحولت الهدايا التي يُفترض أن تُقدَّم برغبة وطيب خاطر إلى مطالب مفروضة، تُقدَّر قيمتها وفق مستوى تعليم العريس ومكانته الاجتماعية. وتعاني الأسر المسلمة الفقيرة أيضًا من هذا النظام، حيث تُسجَّل حالات مضايقة ووفاة مرتبطة بالدوطة في ولايات مثل بيهار وأوترا براديش.
وإن أي إصلاح فعّال لتحقيق التغيير المنشود يجب أن يكون إصلاحًا داخليًا نابعًا من المجتمع ذاته. فعلى المجتمعات المسلمة أن تعود إلى مبادئ الإسلام التي ترفض الدوطة وتؤكد المساواة بين الجنسين. كما ينبغي توعية النساء بحقوقهن، ومحاسبة الرجال على الالتزام بالـمَهر والقيام بواجبات الدعم والرعاية.
ولا بد أن يُمنح الإرث والممتلكات وفق الطريقة الإسلامية الصحيحة، كما أن تعليم المرأة واستقلالها الاقتصادي يعدان أمرين أساسيين لمواجهة الاستغلال. وبالاقتداء بسنة النبي ﷺ في البساطة والعدل، يمكن أن يقود المسلمون الطريق في رفض الدوطة وقطع دابرها. ويرى بعض العلماء أن الدوطة قد تتراجع مع التوسع الحضري، وارتفاع مستوى تعليم النساء، وتقلص الفجوة بين الريف والمدينة في الهند، لكن ذلك سيستغرق وقتًا.
وإن القضاء على الدوطة لا يتحقق بالقوانين وحدها، بل يحتاج إلى إصلاح اجتماعي وتعليم وتكاتف مجتمعي. وعلى الأسر أن ترفض الأعراس الهدايا الباذخة، وأن تختار البساطة. كما ينبغي للقادة الدينيين والمجتمعيين أن يعلنوا موقفًا واضحًا ضد هذه الممارسة، وأن تُدرّس المدارس مبدأ المساواة بين الجنسين منذ المراحل الأولى، لتنشئة جيل جديد يقدّر المرأة كإنسان لا كسلعة.
وقبل كل شيء، لا غنى للمرأة عن الاستقلال الاقتصادي؛ فحين تستطيع أن تكسب رزقها، وتملك ممتلكاتها، وتتخذ قراراتها بإرادتها الحرة، تصبح أقل عرضة للاستغلال. وإنّ تمكينها بالعلم والعمل هو السلاح الأمضى في مواجهة الدوطة، ودرعها الأقوى في معركة الكرامة والعدالة.