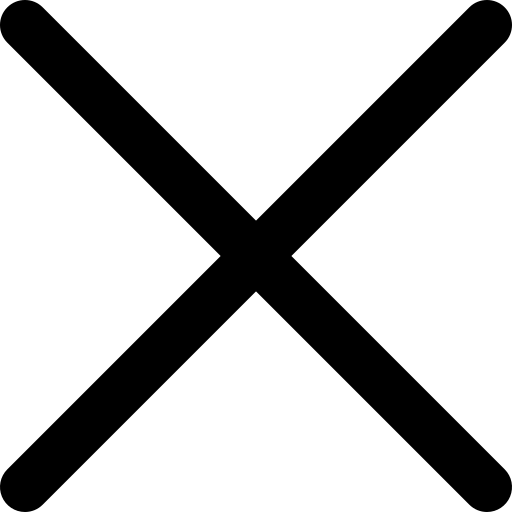ثاقب سليم*
كتبتُ، بعد تفجير دلهي الإرهابي، أن أصحاب المؤهلات العالية أكثر عرضة للانخداع بالأيديولوجيات المتطرفة، لأن الجماعات الإرهابية تفضّل تجنيدهم لقدرتهم على التحرك دون إثارة الشبهات، ولأن تدريبهم العلمي يدفعهم أحيانًا للبحث عن حلول مبسّطة تؤدي بهم إلى العنف.
ويطرح السؤال كيفية الحد من انجراف الشباب المتعلّم نحو الإرهاب. وتقوم المقاربة التقليدية على الحد من التعليم الديني وتعزيز التعليم الغربي العلماني. وهناك اعتقاد قديم مفاده أن التعليم يُسهم في مواجهة الإرهاب، لا سيما التطرّف الديني، وقد دأبت الحكومات على صياغة سياساتها استنادًا إلى هذا الفهم.
وتشير البيانات إلى عكس الفرضية الشائعة؛ فمدارس ديوبند في الهند غالبًا ما تعكس خطابًا وطنيًا علمانيًا، ولم يُسجَّل أن خريجيها نفّذوا هجمات إرهابية كبرى. وبالمقابل، كان يعقوب ميمون، المدان في تفجيرات مومباي، محاسبًا محترفًا، وكثير من الإرهابيين الذين أدانتهم المحكمة في الهند لم يأتوا من المدارس الدينية أصلًا. وبالمثل، فإن معظم الإرهابيين المرتبطين بخالستان وكشمير وباكستان كانوا من خرّيجي الجامعات، وليسوا من طلاب المدارس الدينية.
وفي حادثة التفجير الانتحاري الأخيرة في دلهي، تبيّن أن المنفّذ كان طبيبًا، كما كشفت التحقيقات الممتدّة عبر عدة ولايات عن تورّط عدد من الأطباء ضمن الخلية الإرهابية. وفي ضوء ذلك، ينبغي للحكومة أن تعيد النظر في استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب، إذ تُظهر الخبرة والبيانات أن انتشار التعليم الغربي وحده لا يكفي لوقف الإرهاب والتطرّف.
وخلال المئة عام الماضية، أصبحت المؤسسات التعليمية أماكن أساسية لتجنيد الشباب في مختلف الأيديولوجيات المتطرفة، من اليسار المتشدد إلى اليمين المتطرف. فالمجنّدون يعرفون أن عقول الشباب سريعة التأثّر، ويمكن إقناعهم بسهولة بأن حمل السلاح هو الطريق الوحيد لمواجهة الظلم الذي يُقال إنه يستهدف جماعتهم.
ويُبرز الدكتور أحمد إس. يايلا، الرئيس السابق لمكافحة الإرهاب في تركيا، منهجية دقيقة تتّبعها الجماعات الإرهابية في استهداف المؤسسات التعليمية. فهذه الجماعات لا تعتمد على التجنيد العشوائي، بل تؤسّس لجانًا متخصّصة أو تعيّن عناصر محدّدين لإدارة أنشطة التجنيد داخل المدارس الثانوية والجامعات. ويستند أفراد الجماعات الإرهابية إلى بناء علاقة تدريجية مع الطلاب عبر مساحات اجتماعية تبدو بريئة — مثل الألعاب والرياضة وجلسات المذاكرة — بهدف خلق رابط نفسي واجتماعي قوي. وعندما تُرسَّخ هذه الثقة، يتم الانتقال تدريجيًا إلى عملية الاستقطاب الفكري ثم التجنيد الفعلي.
واشتهرت القاعدة، ولاحقًا تنظيم داعش، باستقطاب شبّان وشابات من جامعات أوروبا، مستفيدة من البيئة الجامعية كمساحة خصبة للتأثير والتجنيد. ويذكر يايلا أنه خلال عمله كقائد للشرطة كان يرى باستمرار جماعات إرهابية تستخدم المدارس والجامعات كمراكز للتجنيد. ويشرح أن المجندين في الجامعات كانوا يركّزون على الطلاب الجدد القادمين من خارج المنطقة، فيقدّمون لهم المساعدة في السكن والطعام وأشكال دعم أخرى، بهدف كسب ثقتهم وبناء علاقة معهم قبل أن يعرف هؤلاء الطلاب حقيقة الجهة التي تتواصل معهم.
ويؤكد الدليل التدريبي لتنظيم القاعدة أن المؤسسات التعليمية هي أفضل أماكن للتجنيد لأنها تضم شبابًا حماسيين ومعزولين لسنوات. ويشدد على ضرورة غرس فكر الجهاد في طلاب الثانوية منذ الصغر، مع التحذير من التسرّع. ويرى الدليل أن هؤلاء الشباب مناسبون للتجنيد لأن عقولهم ما تزال نقية وسهلة التشكيل، وقابلة للتأثير، ولأن التعامل معهم آمن، لأن احتمالية كونهم جواسيس ضعيفة.
وتُظهر تجارب داعش والقاعدة أن الجماعات الإرهابية باتت تخترق الأوساط المهنية الراقية للتجنيد. وتشير التحقيقات في تفجير القلعة الحمراء إلى هذا الأسلوب أيضًا؛ إذ تبيّن أن طبيبًا واحدًا نجح في التأثير على أطباء آخرين يعملون في كلية طب معينة، ما يكشف عن نمط تجنيد يعتمد على النفوذ داخل الفئات المتعلّمة.
ويُظهر الهجوم الإرهابي بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا عام 2019م، ما خلَّف 51 قتيلًا و50 جريحًا، من بين 300 مصلٍّ في الجامع، كيف تستخدم الجماعات الإرهابية وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة التطرف؛ إذ نشر المنفّذ بيانه العنصري على تويتر قبل الهجوم بيوم. ورغم تعليق حسابه بعد الهجوم، فإن البيان المكوّن من 74 صفحة والمفعمة بالكراهية ضد المهاجرين انتشر بسرعة كبيرة قبل الإيقاف. كما استخدم كاميرا مثبّتة على رأسه لبثّ الهجوم مباشرة عبر فيسبوك.
ومع أن حساب المهاجم على فيسبوك أُزيل لاحقًا، فإنه كان قد بثّ الهجوم لمدة 17 دقيقة، مما أتاح انتشارًا أوسع لبيانه وروايته. وقد تفاقم الأمر حين نُسخ الفيديو وتداول بشكل واسع؛ إذ حذف فيسبوك 1.5 مليون نسخة في أول 24 ساعة، ثم اكتشف مئات النسخ الأخرى لاحقًا. وتُظهر هذه الحادثة كيف تُسهِم منصّات التواصل في توسيع نطاق الدعاية الإرهابية بشكل غير مسبوق.
كما تلفت سارة زيغر وجوزيف غايت الانتباه إلى مثال يكشف البعد الإعلامي في عمل التنظيمات المتطرفة، وذلك من خلال مثال سيتي خديجة المعروفة باسم أمّ صبرينة. فقد لعبت هذه الإندونيسية دورًا مركزيًا في إدارة صفحات فيسبوك المرتبطة بـ "أخبار العالم الإسلامي" (KDI)، الجناح الإعلامي لتنظيم داعش في إندونيسيا. وقد ذاع صيتها بعد أن نشرت على فيسبوك، في يونيو 2014م، تجربتها في السفر إلى سوريا مع زوجها وأطفالها الأربعة.
وبعد ذلك بدأت سيتي خديجة تنشر بانتظام عن حياتها في سوريا، وكانت تروج الرواية الإيجابية التي يصنعها التنظيم عن الرواتب الشهرية، والتعليم المجاني، والرعاية الصحية المجانية، وحسن معاملة عائلتها. ومع الوقت، امتلأت صفحتها على فيسبوك بأسئلة من إندونيسيين يرغبون في معرفة كيفية السفر إلى سوريا. ومن بينهم شخص يدعى على فيسبوك "صبرًا يا نفسي"، تأثر بقصتها وسافر مع عائلته إلى سوريا عام 2015م، لكنه قُتل لاحقًا هناك.
وفي السياق الهندي، شكّلت قصة برهان واني نموذجًا لنجاح الدعاية المتطرفة في اختراق الوعي الشبابي عبر وسائل التواصل. فقد تحوّل واني إلى "أيقونة" بين بعض شريحة الشباب الكشميري بعد أن انتشرت صوره وهو يحمل السلاح بشكل واسع على فيسبوك ومنصّات أخرى. وقدّمت هذه الصور سردية جذابة للإرهابيين. فشاب "اضطرّ" إلى حمل البندقية، و"فتيات يعجبن بصوره".
كما ظهرت حسابات على وسائل التواصل تروّج لما يُسمّى بـ"التطرّف الناعم"، من خلال إقناع الشباب بأن "مجتمعهم" يتعرّض لهجوم من "عدوّ"، مما يزرع فيهم شعورًا بالخطر يقودهم نحو التطرف.
وفي ظل الإنترنت والذكاء الاصطناعي، لا يمكن حجب المحتوى المتطرف بالكامل. فهناك أدوات تمكّن المستخدمين من الوصول إلى المواقع المحظورة. ولذا يجب على أجهزة مكافحة الإرهاب مواجهة الدعاية المتطرفة مباشرة عبر الفضاء الرقمي، من خلال نشر روايات إيجابية مضادّة على منصّات التواصل، وتقدّم لهم حلولًا بديلة لمشكلاتهم بعيدًا عن العنف.
وتشير زيغر وغايت إلى أن مكافحة التطرف لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات الأمنية أو الرقابة التقنية، بل تتطلّب استراتيجية سردية شاملة. فهذه الاستراتيجية ينبغي أن تؤدي وظيفتين مترابطتين: تفكيك الخطاب الإرهابي، وإنتاج روايات إيجابية وبديلة.
اقرأ أيضًا: ضبابٌ لا صوت له… هكذا يتسلّل التطرّف
ويمكن أن تقدّم المؤسسات التعليمية برامج توضّح للشباب أهمية الطرق الديمقراطية السلمية في حلّ المشكلات الاجتماعية. وعلى الشباب أن يفهموا أن المظلومية التي تصوّرها الجماعات الإرهابية مبالغ فيها، وأن العنف ليس سبيلًا لحلّ أي مشكلة.