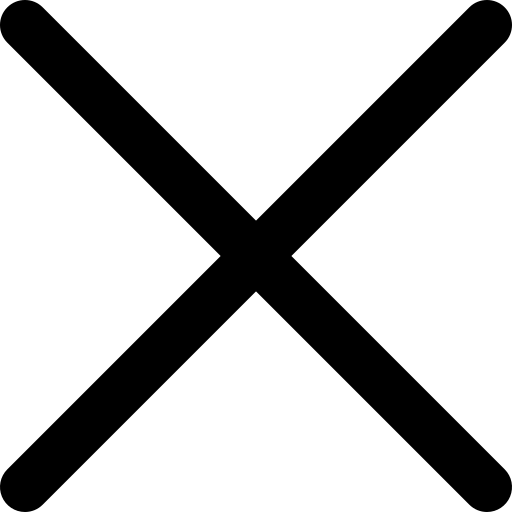أويس ثقلين أحمد*
كانتالطفلة تُعرَف باسم "جين دو"—لا بحثًا عن إخفاء هويتها، بل لأن هويتها انتُزعت منها بالكامل. كانت عاملة منزلية إندونيسية محتجزة في ظروف استعباد قاسٍ، وجدت نفسها أسيرة شكل متطور من العبودية داخل شقّة فاخرة في مانهاتن، تحت سلطة أسرة نافذة. صادروا جواز سفرها، وأجبروها على العمل لما يقرب من 16 ساعة يوميًا، ولم يدفعوا لها شيئًا تقريبًا في مشهد يجسّد كيف يمكن للعبودية الحديثة أن تتوارى خلف الواجهات البراقة. ومع ذلك، فقد امتلكت الشجاعة للفرار، وحصلت على ملاذ آمن، وأبلغت عن الجريمة. ولكن العقبة الجوهرية ظهرت لاحقًا. كان الدبلوماسي السابق مشعل الحسن وزوجته، مرتكبا الجريمة، يتمتعان بحصانة دبلوماسية تعقّد الوصول إلى العدالة.
ولا تمثّل هذه المظلومية الفردية سوى نموذج مصغّر لكارثة عالمية تتسع بصمت. فهناك قوة عاملة تعمل في الظل، تكشف عن اتساع الهوّة بين الخطاب الأخلاقي الذي نرفعه والممارسات الفعلية التي تُكرّس الاستغلال. هذا هو العالم الخفي للاقتصاد غير المرئي، حيث يُقدَّر عدد المحتجزين في العمل القسري بنحو 27.6 مليون شخص، وأكثر من ثلثهم يُتاجر بهم تحديدًا ليقعوا في فخ العبودية المنزلية.
ويدرّ هذا الاستغلال العنيف في قطاع العمل المنزلي وحده، أرباحًا غير مشروعة تُقدَّر بنحو 2.6 مليار دولار سنويًا. ويصل حجم الأرباح الناتجة عن العمل القسري، على النطاق العالمي، إلى نحو 236 مليار دولار، في ما يشبه اقتصادًا مظلمًا يعمل خارج القانون، ويستمد قوته من استغلال أكثر الفئات هشاشة. ويكشف هذا الواقع كيف تتحول المعاناة الإنسانية إلى مورد اقتصادي تُبنى عليه أرباح هائلة، فيما يبقى الضحايا خارج منظومة الحماية والقانون.
ولكن السؤال الجوهري يبقى: حين يُحرَم الإنسان من العدالة بسبب المكانة والامتياز، فما الذي يحدّد قيمتنا الحقيقية؟ نحبّ أن نتحدث عن العبودية الحديثة وكأنها فصل من الماضي. لكنها ليست كذلك. إنها تحدث اليوم، في شقق فاخرة، وفي هذه اللحظة تمامًا. وهذا الاختبار، الذي يعود إلى ما يقرب من 1400 عام، لا يقيس النفوذ ولا المكانة، بل يقيس الضمير.
ونحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، في كلّ عاشر من ديسمبر، بنشر الرسوم والبيانات التي تحتفي بالعدالة والمساواة. ثم نعود إلى منازلنا، لنمارس تناقضًا صارخًا، ونطلب ممن ينظّف أرضياتنا أن يواصل العمل لوقت متأخر، من دون أن نسأل سؤالًا بديهيًا عمّا إذا كان قد تناول طعامه. وهذا المشهد يكشف فجوة مؤلمة بين خطابٍ نردّده وواقعٍ نغضّ الطرف عنه، وبين قيم نعلنها وممارسات لا تعكسها.
وقبل أربعة عشر قرنًا، صادف النبيّ محمد ﷺرجلًا يُدعى سلمان الفارسي في أحد أيام المدينة يحمل جريد النخل على ظهره، منهكًا من ثقل الحمل. كان سلمان يومها عبدًا مملوكًا، ويعمل بالسُّخرة، ويجرّ أثقالًا تعجز عنها طاقة البشر. ولم يقدّم النبيّ ﷺموعظة. وكل ما فعله أنه اقترب من سلمان، ثم رفع بعض الجريد وحمله معه. كان هذا الفعل البسيط أبلغ من أي خطبة؛ مشاركة صادقة تخفّف الحمل وتعيد للإنسان إحساسه بكرامته.
وحين بلغ خبر مساعدة النبي ﷺلسلمان سيدَه، غضب وقال مستنكرًا: "أتساعد عبدي؟". فجاء موقف النبي ﷺمنسجمًا مع ما أرسته السنّة من مبدأ أخوة الإنسان للإنسان؛ إذ ورد عنه ﷺقوله: "هُم إخوانُكم خَوَلُكم، جَعَلَهم اللهُ تحت أيْديكم، فمَن كان أخُوه تحت يَدِه فلْيُطعِمْه ممَّا يَأكُلُ، ويُلبِسْه ممَّا يَلبَسُ، ولا تُكلِّفوهم ما يَغلِبُهم، فإنْ كَلَّفتُموهم فأعينُوهم، ومَن لم يُلائِمْكم منهم فبِيعوهم، ولا تُعذِّبوا خَلْقَ اللهِ". وهو الحديث الذي رسّخ أن العبد أخٌ قبل أن يكون مملوكًا.
وبعد أسابيع قليلة، صار سلمان حرًّا. وأصبح بعد ذلك من كبار الصحابة، ومن أكثرهم علمًا وبصيرة، بل ومن الشخصيات التي كان لها أثر بارز في تاريخ الإسلام المبكر.
وقد حسم القرآن هذا المبدأ بوضوح حين قال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ"، (الحجرات: 13).
إنها آية تنقض كل أشكال التمييز، وتعيد بناء معنى القيمة الإنسانية من جديد. فليست المناصب ولا الألقاب هي التي تصنع مكانتك… بل أخلاقك هي التي تمنحك قيمتك الحقيقية.
وخلال كأس العالم عام 2022م، ظهر حمد صلاح وهو يرتدي قميصًا يحمل عبارة تدعو إلى دعم حقوق العمال. فجاء الهجوم سريعًا: "التزم بالرياضة"… "ولا تتدخل في السياسة".
ولكن صلاح كان يعرف تمامًا ما يجري خلف الأضواء: أحوال عمال الهجرة الذين شيّدوا تلك الملاعب، الوفيات، سرقة الأجور، جوازات السفر المصادَرة.
وفي وقت لاحق، شرح موقفه ببساطة إنسانية مؤثرة: "جدّي كان يعمل في البناء. ولو لم تُحترَم حقوقه، فلن تُصلِح أي صلاة هذا الظلم".
والسكوت عن الظلم شراكة في الإثم، وشراكة في العقوبة؛ ففي الحديث: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه".
وأوّل وثيقة دستورية في الإسلام لم تكن عن مواقيت الصلاة، بل كانت في جوهرها وثيقة لحقوق العامل. فوثيقة المدينة التي كُتبت عام 622م أكدت هذا المبدأ بوضوح، وجاء في المادة 15: "أُعطوا العامل أجره قبل أن يجف عرقه". ليس لاحقًا… بل في اللحظة نفسها.
وذهبت المادة 23 خطوة أبعد، فنصّت على:"لا يُكلَّف العامل ما لا يطيق، ولا تُمسّ كرامته في أي عمل يُطلب منه".
ويعمل اليوم نحو 2.4 مليون عاملٍ وعاملةٍ منزلية في بيوت الخليج، وكثير منهم نساء من جنوب آسيا وإفريقيا لم يرَين عائلاتهن منذ سنوات.
ومن بينهنّ عائشة، التي تعمل في دبي وهي من بنغلاديش. واحتفظ صاحب عملها بجواز سفرها — وهو أمر غير قانوني — لكنها لا تعرف إلى من تلجأ. وتعمل ست عشرة ساعة في اليوم، وحين طالبت بحقّها القانوني في يوم راحة أسبوعية، ردّ عليها صاحب العمل بجملة تحمل استغلالًا مُغلَّفًا بالدين: "دينك يعلّمك الصبر، أليس كذلك؟"
والحقيقة أن كثيرًا مما نراه ممارسات اجتماعية متوارثة، ليس بالضرورة من مبادئ الإسلام ولا من قيمه.
وحبس النساء داخل البيوت؟ هذا ليس من الدين، بل عادة اجتماعية تُقدَّم على أنها "تقاليد".
ودفع رواتب أقل للعمّال لأنهم أجانب؟ هذا استغلال اقتصادي تُعطى له مبررات دينية.
ومنع العامل من الراحة بحجة أننا "نُعطيه أجرًا"؟ تلك عبودية معاصرة تُغلَّف براتب.
والتضامن الحقيقي ليس أن ندافع عن "أهلنا" بينما نتجاهل الظلم داخل بيوتنا. وليس أن نكتب عن القهر في أماكن بعيدة، ثم نُطبِّع الاستغلال في مطابخنا.
والتضامن الحقيقي يبدأ حين نعترف بأن الشخص الذي ينظّف أرضياتنا يحمل الشرارة الإلهية نفسها التي ندّعيها لأنفسنا.
وتذكّرنا النصوص الدينية والسيرة بأن كرامة الإنسان أساس لا يتغيّر، وأن الدفاع عن الحقوق لا يكون بالشعارات بل بالممارسة اليومية. فقبل الحديث عن ظلمٍ بعيد، يجدر بنا أن نسأل كيف نعامل من يعملون في بيوتنا وأماكننا: هل نعرف أسماءهم؟ هل نؤدي حقوقهم؟ هل نمنحهم ما نرجوه لأنفسنا؟
اقرأ أيضًا: قصة خالي… حين حاولت قرية في كشمير أن تواجه العاصفة بالوحدة
فالإيمان الحقيقي يُقاس بمدى احترامنا لمن لا يملكون إلا الثقة بنا، لا بعدد ما نعلّقه من شعارات عن العدالة.