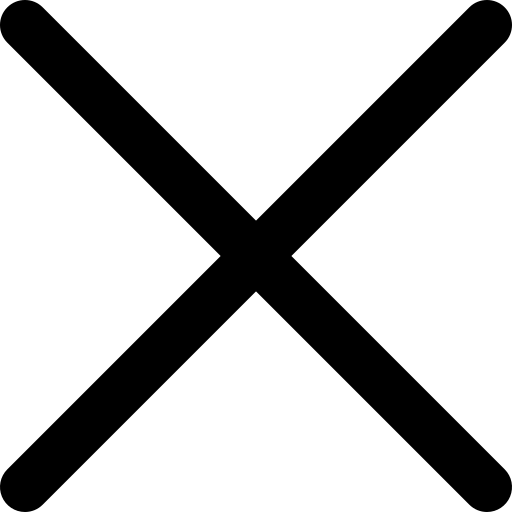ويدوشي غور*
وُلدتُ في مدينة لكناو وترعرعتُ بين أزقتها، تلك المدينة التي لا تُقال فيها التهذيب (الثقافة) بالكلمات، بل تُعاش وتُستنشق مع الهواء. هنا لا يجاور الناس بعضهم فحسب؛ بل تتداخل حكاياتهم مثل خيوط تطريزة واحدة. نشأتُ في أسرة هندوسية، تحيط بي الطقوس والعادات وإحساسٌ هادئ بما تعنيه ثقافتنا. ومع ذلك، كانت طفولتي تهمس لي دائمًا بأن القلوب لا تعترف بالحدود.
ومن أوّل ما أتذكّره من طفولتي ما يعطي مثالا حيا للتعايش بين المسلمين والهندوس، هو مساء ديوالي. كانت أمي تُشعل آخر مصباح ديوالي"دِيا"، حين طرق بابَنا أحدٌ. وكان الطَّرق مألوفًا. كانت عمتنا رُخسانة وقفت أمامنا تحمل طبقًا منالسِّيوَي الساخن، يعدّه المسلمون للاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى. ويُعدّ الحلوى الأهم التي تُقدَّم للعائلة والأصدقاء في أجواء الفرح التي ترافق ختام شهر رمضان. وكان السِّيوَي ساخنًا حتى إنّ بخاره كان يضبّب نظّارته. وكانت ُخسانة تبتسم دائمًا وهي تقول: الضيافة لا تعرف دينًا، ثم تضع الطبق في يد أمي قبل أن نتمكّن من الاعتراض.

وفي كل عام، كان الرانغولي الذي نصنعه و السِّيوَي الذي تُحضره يجلسان جنبًا إلى جنب على المائدة؛ ألوانٌ زاهيةٌ بجوار حلاوةٍ دافئة، كأن الكون خطّط لهذا اللقاء منذ زمن، قبل حتى أن نفهم معنى الأعياد.
وكانت طفولتنا أبسط ما تكون، كما لو أن العالم كلّه كان أوسع وأكثر خفة. وفي الهولي، كنتُ أركض خلف صديقتي عائشة بينما يتطاير الغولال في الهواء كأنه قصاصات ملوّنة تهطل من السماء. كانت تضحك، تهرب، ثم تفتح خزانة أمها وتخرج منها قليلًا من آلتا — صباغٌ أحمر جميل تستخدمه الثقافة الهندية في المناسبات الميمونة—تمرّره على وجهي في لحظة خاطفة. ومن سطحٍ قريب، نادانا أحدهم: الآن تبدوان متشابهتَين تمامًا.
ومع مرور السنين، لم تفقد لكناو رقتها؛ بل ازدادت عمقًا. وأتذكّر ذهابي مع أصدقائي من الجامعة إلى الـإمامبارة—وهي قاعات تجمعٍ شيعية في جنوب آسيا لإحياء ذكرى الإمام الحسين ومجالس العزاء—بعد أحد الامتحانات، لنلوذ من الحرّ. وما إن دخلنا حتى خلعتُ حذائي تلقائيًا، فهَمَس لي أمان أحمد: لا حاجة لذلك. ابتسمت وقلت: الاحترام لا ينتظر القواعد. وبعد أسابيع، كان أمان يقف في بيتي خلال عبادة "سندر كاند"، يضمّ يديه بخشوع أثناء الآرتي، ويسأل بهدوء عن معنى البرساد. وفي تلك اللحظة شعرتُ وكأن الحياة أتمّت دورتها بصوتٍ خافت وجميل.

ومن أجمل ذكرياتي في منطقة تشوك خلال رمضان أن طفلًا صغيرًا دعاني للجلوس معه وقت الإفطار. أخبرته أنني لستُ صائمة، لكنه هزّ رأسه بثقة طفولية وقال: لا بأس… الله يدعو الجميع. كانت لحظة بسيطة، لكنها كشفت لي عمق كرم الروح في لكناو.
فجلستُ بينهم، فتاةً وسط وجوهٍ لا أعرفها، لكنها لم تبدُ غريبة عليّ. واقتسمنا تمرةً تذوّقتُ فيها حلاوةً لم أشعر بها من قبل. وعندها أدركتُ أن الدفء لا يحتاج إلى ضجيج؛ لفتة صغيرة، دعوة رقيقة، ابتسامة، أو مكان يُفسَح لك… تكفي لتذيب الخوف قبل أن يولد.

ولم تكن مدينة لكناو تُلغي الفوارق بين الناس، بل كانت تحوّلها إلى جزء طبيعي من نسيج الحياة اليومية. فهنا ينتظر موكبُ جنازة احترامًا ليعبر موكبُ زفاف. فمن الطبيعي هنا أن تمتزج أصواتُ القوّالي مع رنين أجراس "الآرتي" في المعبد المقابل.
ويسألني الناس أحيانًا لماذا أؤمن بالتعايش بهذا القدر. ولا أعرف كيف أشرح لهم ذلك كاملًا. ربما لأن طفولتي كانت تحمل رائحة كلٍّ من العود والعِطر؛ ولأن أول كلمات الشكر التي تعلمتها جاءت بلغتين: "شكريه" و"دهنيَاواد".
اقرأ أيضًا: حين تتحول نظرة المجتمع من عائق إلى جسر… يبدأ الإدماج الحقيقي
وأؤمن بالتعايش لأن طفولتي في مدينة لكناو كانت تمزج الروائح واللغات والذكريات في انسجام واحد؛ فقد رأيتُ بأمّ عيني كيف تتشابك الأيدي بدل أن تتقابل كطرفين. ولهذا لم أتعلم محبة الاختلاف من الكتب، بل من الحياة نفسه. فقد ربّتني لكناو برفق وعلّمتني أن السلام لا يعني أن نصبح متشابهين، بل أن نختار أن ننتمي لبعضنا رغم اختلافنا.