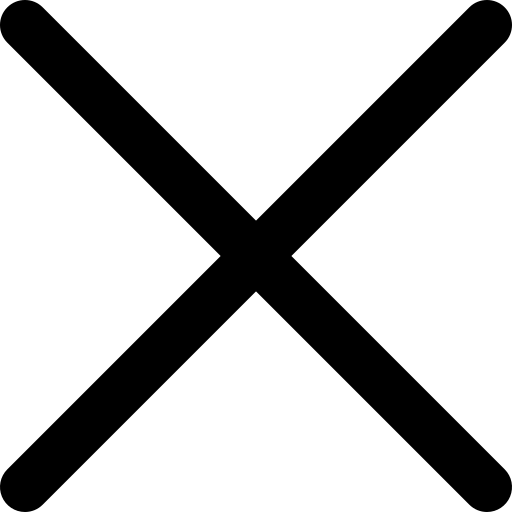.jpg)
بلّب بهاتاشاريا*
لم يكن الانفجار قرب القلعة الحمراء في دلهي يوم 10 نوفمبر مجرد اعتداءٍ عنيف على المدينة، بل تحول نقطة اشتعال فورية للمشهد الوطني المعتاد في البلاد، إذ انتقلت المأساة خلال لحظات إلى محاكمة متلفزة جاهزة، قبل أن تتضح الحقائق كاملة.
ومع اندلاع النيران في سيارة هيونداي i20، البيضاء، ومقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة آخرين، سارعت وسائل الإعلام إلى ملء غياب المعلومات بسيلٍ من الصور والقصص والفرضيات والأسماء، فبدأت هذه الروايات تُشكّل الرأي العام قبل أن يتوفر للمحققين أو القضاء ما يكفي من الحقائق للحديث بثقة.
وإن هذا التوتر بين حرية الصحافة وحقّ المتهم في محاكمة عادلة يشكّل جوهر المعضلة التي تعاني منها الهند باستمرار في ما يُعرف بـ"المحاكمات الإعلامية". فالدستور يكفل حرية الكلام والتعبير بموجب المادة 19(1)(أ)، لكنه في الوقت نفسه يقيّد هذه الحرية عبر المادة 19(2)، التي تجيز فرض قيودٍ معقولة لحماية العدالة والنظام العام. كما يوضح قانون ازدراء المحاكم لعام 1971م أن أي نشر قد يؤثّر سلبًا في محاكمة منظورة يُعد ازدراءً جنائيًا، بما يعزّز مضمون المادة 21 التي تضمن الإجراءات العادلةوقد حذّرت المحاكم مرارًا من أن قرينة البراءة لا يجوز المساس بها منذ اللحظة الأولىعبر تغطية مثيرة تقدّم نفسها بوصفها "خدمة للصالح العام".
وقضت محكمة البنجاب وهاريانا العليا، في قضية راو هار نارايان سينغ شيوجي سينغ ضد غوماني رام آريا، بأن نشر تفاصيل تخمينية عن المشتبه بهم أو الشهود يُضعف نزاهة العملية القضائية ويقوّض العدالة. واعترفت المحكمة العليا المركزية بدور الصحافة وتأثيرها، لكنها أكدت أن هذا الدور لا يجب أن يطغى على حق الدفاع أو يعرقل التحقيق المحايد. وأما في قضية شركة سهارا إنديا العقارية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI)، فقد ذهبت المحكمة إلى أبعد من ذلك حين أقرت بضرورة إصدار "أوامر التأجيل" عند الحاجة، لمنع الإعلام من تلويث العملية القضائية أو التأثير على مسارها الطبيعي.
ومع ذلك، تبدو هذه الضمانات عاجزة أمام منظومة إعلامية تُسيّرها السرعة ومنطق المنافسة وافتتانها بصناعة المشهد. ويقدّم التاريخ أمثلة موجعة على كيف تمكّنت التغطية المتعجّلة من تشويه مسار العدالة. ففي قضية آروشي تلوار، أدانت المنظومة الإعلامية باتهاماتها المتعجّلة الوالدين في الوعي العام، قبل أن تبرّئهما المحاكم بسنوات، تاركةً جراحًا لا تندمل في حياتهما وسمعتهما.
وعلى الجانب الآخر، تكشف قضية جيسيكا لال الدور البنّاء الذي يمكن أن يلعبه الإعلام؛ إذ أسهمت الصحافة الاستقصائية، والحراك الشعبي، في الدفع نحو إعادة المحاكمة، ما أتاح للعدالة أن تأخذ مجراها في النهاية. وهذه الثنائية — الإعلام كحارس للعدالة وكمصدر لتهديدها في آنٍ واحد — برزت بوضوح أكبر في قضية سوشانت سينغ راجبوت، حين وجّهت محكمة بومباي العليا انتقادًا لاذعًا لبعض القنوات بسبب تغطية "مسيئة للمحكمة"، إذ قامت بتشويه صورة ريا تشاكرابورتي قبل أن يظهر أي دليل فعلي.
وفي هذا السياق المتوتر، كان انفجار القلعة الحمراء يتطلّب مستوى عاليًا من التغطية الدقيقة والمستنِدة إلى وقائع، وهو ما تتطلّبه أي ديمقراطية. فالقضية بطبيعتها شديدة التعقيد: تبدأ من دور الطبيب عمر محمد، وتمتدّ إلى الاشتباه بارتباطات مع شبكة راديكالية تضمّ مهنيين في القطاع الطبي، مرورًا باستخدام قنوات تلغرام مشفّرة، ووصولًا إلى الضبطيات السابقة لما يقرب من 2,900 كغم من المتفجرات عبر ولايات مختلفة—وكلها مؤشرات تشير إلى بنية مؤامرة متقدمة لا تزال أجهزة التحقيق تحاول فكّ طبقاتها المتعددة.
وجرى استجواب أكثر من سبعين شاهدًا في دلهي وما جاورها، وتم فحص الأدلة بدقة، وتتبع الخيوط عبر ولايات مختلفة — وكل ذلك يعكس حجم الخطر ويؤكد الحاجة إلى تحقيق متواصل ومنهجي.
ولكن بينما كانت جهات التحقيق تواصل عملها، كانت رواية أخرى تُنسَج بالتوازي في الوقت نفسه. وعرضت بعض القنوات مقاطع تشرح طريقة صنع المتفجرات، فيما انتشر على الإنترنت مقطع مزيف لانفجار هائل، حاصدًا أكثر من مليون مشاهدة قبل أن تُفنّده الحكومة رسميًا. وأما الأشخاص الذين تم توقيفهم ثم الإفراج عنهم لعدم وجود أدلة، فقد وُضعت أسماؤهم ومهنهم تحت أضواء النقاش التلفزيوني، لتتضرر سمعتهم حتى بعد ثبوت براءتهم.
وقد أصدرت وزارة الإعلام توجيهًا يدعو إلى ضبط النفس، محذّرة من أي محتوى قد يروّج للعنف أو يعرّض الأمن القومي للخطر. وهكذا تحوّل الحادث إلى مثال آخر على كيف يمكن للمعلومات المضلِّلة، والتكهنات المتسرّعة، والمواد البصرية المثيرة أن تشوّه فهم الناس، وتربك ذاكرة الشهود، وتُعرقل الإجراءات القضائية التي يفترض أن تبقى نزيهة وعادلة.
وقد أدركت المحاكم منذ زمن خطر تأثير الإعلام على مسار العدالة؛ فاجتهاداتها في قضايا "المحاكمات الإعلامية" تعبّر عن المخاوف نفسها التي برزت عالميًا، سواء في "قضية شيبارد ضد ماكسويل" في الولايات المتحدة أو في السوابق البريطانية التي تفترض تأثّر المحلّفين عند اطلاعهم على معلومات خارج ملف الأدلة. ورغم أن الهند لا تعمل بنظام المحلّفين، فإنها ما تزال تواجه خطرًا أدقّ يتمثل في إمكانية تأثر القضاة بالسرديات العامة الطاغية المحيطة بالقضية.
ولا يقتصر الضرر على المتهمين وحدهم. فعوائل الضحايا تجد أحزانها تُحوَّل إلى مادة درامية قابلة للاستهلاك. والشهود يتعرّضون لاحتمالات الترهيب أو التأثير. وأما المحققون فيشعرون بضغوط تدفعهم إلى تقديم نتائج سريعة بدلًا من نتائج دقيقة. ومع هذا كله، تتزعزع ثقة المجتمع حين يبدو أن العدالة تُصاغ من خلال العناوين الصاخبة بدلًا من الأدلة. لقد أظهر انفجار القلعة الحمراء مرة أخرى مدى هشاشة الثقة العامة عندما يذوب الحدّ الفاصل بين المعلومة والترفيه.
ومع ذلك، فالحلّ لا يكمن في الرقابة ولا في الاستسلام، بل يكمن في تعزيز الضوابط الأخلاقية داخل المؤسسات الإعلامية، وتطبيق قوانين ازدراء المحكمة عند الحاجة، والمطالبة بالدقة والتمحيص، وإعطاء مساحة واضحة لتصحيح الأخطاء، إلى جانب نشر الوعي الإعلامي بين الناس. فصحافة المراقبة—المبنية على الاستقلال والتحقّق والمساءلة—تظل عنصرًا أساسيًا في أي ديمقراطية. وأمّا الإثارة الإعلامية، فلا تخدم أحدًا سوى من يستثمرون في الخوف.
اقرأ أيضًا: ضبابٌ لا صوت له… هكذا يتسلّل التطرّف
وفي النهاية، فإن ضحايا انفجار القلعة الحمراء يستحقون عدالة هادئة وواضحة، لا يربكها الضجيج ولا تشوّهها الأحكام المسبقة والقراءات المتعجلة. وإذا كانت هذه المأساة تحمل درسًا واحدًا، فهو أن الحقيقة لا تُنتزع بالاستعجال، بل تتطلب صبرًا وشجاعة وقدرًا كبيرًا من ضبط النفس—وهي قيم ينبغي للمؤسسات الإعلامية أن تستعيدها إذا أرادت الحفاظ على ما تبقى من ثقة الجمهور. فعندما يتحوّل السعي إلى العدالة إلى مادة ترفيهية، لا يخسر الوطن أرواح أبنائه فقط، بل يخسر أيضًا ثقته المتآكلة في المؤسسات التي يفترض أن تصونها.